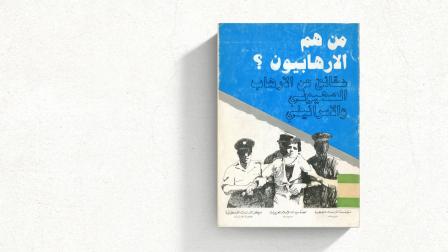وما أفعل يا رب؟ لديّ رابطةُ الأُلفة في عينيَّ، حيثما حللتُ وأنّى توجّهتُ. كلُّ مكان أُقيم فيه لو شهراً، آلفُه، وبعد هجرانه قد أحنّ إليه. علاقتي بالأماكن حميمةٌ، لأني أعتبرُها امتداداً لرحم الأمّ رحمها الله.
عندما أتجوّلُ بعيداً عن أمكنةِ الطفولة المألوفة، وكذا أمكنة الشباب والكُهولة والشيخوخة، في وطن محتلٍّ أو منفى حرّ، تعدّدت أسماؤه، دون قصدٍ وحسبَ اتجاه الريح، أروحُ أحنّ بعد فترة، لكلّ مكان تركته خلفي مرغماً (لم أترك بيتاً في حياتي بدون قسر وإرغام)، أحسّ وقتها كأنني أخبُّ في ما يشبه الدُّوار.
أجل والله. لا إحساس لدي بالزمان، كوني أعرفُ ألّا فائدة من وراء ذلك، ولا حتى منطق، ما دُمنا نعيش في دائرة زمنية تبدأُ من لحظةِ الولادة وتمّحي لحظة الموت، ما دُمنا محكومين بالموت المحتّم، لمَ إذن نهتمّ بوقتٍ أو عمر أو مرحلة منه، لمَ نهتم حتى بأسماء الأيام، إلى الفناء نغذُّ الخطى، ونمشيها سواء كُتبت علينا أم لا؟
الإحساس بالزمن، بعبء الساعة، وبزحمة إكراهات المواعيد، لهو عبودية عصرنا الرأسمالي الراهن: تمشي فترى من حولك ـ خاصةً هنا في غرب أوروبا ـ كلّ الناس وقد وقعوا تحت دكتاتورية الوقت، حتى أنّ جميعهم، يشكون، بمن فيهم فئةُ الشباب، من ضيقه وشحّه. لهذا كلما سمعتَ شكوى كهذه، تأتيكَ أحياناً من صبيّة زهراء تُشرف على إدارة حياتك هنا، لا مفرّ: تبتسمُ وأنت تتذكّر كيف كانت جدّتك وأمّك وجدّك وأخوالك وأعمامك، وأنت، وجيلٌ ممّن وُلد بعدك، بلا ساعات في المعاصم، ويقدّرون الوقت، دون أيّ شعور بعبئه، بحركة الشمس ودورانها حول الأرض.
أحبّ الأماكن، مع أنّني لا أحبُّ بالعموم أن أنام إلّا في فضاءٍ مفتوح: شارع أو رصيف أو غابة أو حقل. رئتاي لا تتوسّعان إلا هناك. ولا ألتفّ على سَكِينتي، إلّا لو نمتُ وأنا أتلفّتُ للناس يعبرون الطريق. إنها أُلفة القلب البريء، ونُبل السريرة، أمّا عدم التعلّق بأي مكان، فاثنان قادران عليه أو حتى ثلاثة: وحش وإلهٌ وشاعر مقطوع من مَسرّة.
* شاعر فلسطيني مقيم في بلجيكا