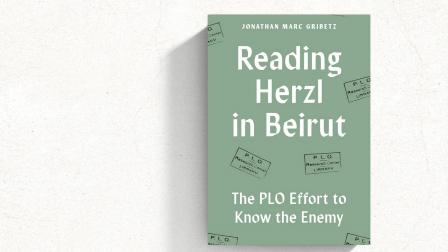بدأ كلُّ شيءٍ بمزحة.
عندما رأيتُ فوضى الناس المتزاحمين في الشارع، تذكّرتُ أنّني سمعت ضجيجهم بينما كنتُ أقرأ، من دون أن يتمكّن من إخراجي من جوّ الرواية، على الرغم من ارتفاعه.
كان هناك تلاميذ بحقائب مدرسية، نساءٌ عائداتٌ إلى بيوتهنّ بأكياسٍ ملأى بالحاجيات، صبيُّ مصبغة يحمل قميصاً رجالياً مغلّفاً بكيسٍ شفّاف، رفيقان يمشيان بكتفين متلاصقتين، ويرميان مجموعة فتيات عند مدخل إحدى البنايات بنظراتهما... قرأتُ على لافتةٍ قماشيّةٍ خضراء ممدودة عبر الشارع بين بنايتين عبارة "شجّع فريق بلدك"، وعلى عربة خشبية مدهونة حديثاً بطلاء أزرق: "لو خلص الفول أنا مش مسؤول".
تغيّرت أسماء المحلّات التجارية، ونشأت أُخرى لم تكن موجودةً من قبل، كمكاتب المحامين وعيادات الأطباء و"معامل" التحاليل الطبيّة، التي نسمّيها نحن مختبرات، ومحلّات الملابس، وتلك العديدة الخاصّة ببيع الأسماك والمأكولات البحرية الطازجة، أو قليها وشيّها، ومنها "محلّات الحاج صفوت الجرجاوي وأولاده"، وحملت السيارات لوحات تسجيل مصرية. تحوّل الحيّ البيروتيّ الهادئ إذاً، هكذا بسرعة وبساطة، إلى حيٍّ إسكندرانيٍّ مكتظّ بالسكّان وضاجٍّ بأنشطتهم.
علمتُ أنّ ثمّة مسلسلاً مصرياً تجري متابعة تصويره هنا. كان هذا شيئاً غير مألوف على الإطلاق؛ أن تُترَك مصر بمساحاتها الهائلة وأحيائها الطبيعية، ويُنقَل الممثّلون والفنّيون والتقنيون مع معدّاتهم لصُنع حيٍّ مصري في مكانٍ بعيد!
ليس الضجيج وحده، بل حتى التغيير الكبير الحاصل في الحيّ الذي أعيش فيه منذ سنتين، لم يُخرجني من أجواء الرواية، بل بدا بأنّه يُدخلني في تفاصيلها، فقد كنتُ منصرفاً خلال يومَيّ عطلتي لقراءة "خان الخليلي" لنجيب محفوظ.
كان التصوير متوقّفاً، ومساعد المُخرج يعطي ملاحظاته المتنوّعة للكومبارس الكثيرين، فاجتزتُ الشارع في طريقي لجلب شيءٍ آكله. التفتُّ إلى الوراء عند مدخل الحيّ، بعد أن خطرت في بالي فكرة دعابةٍ عَلِمتُ أنّها ستُحدث بلبلةً، وتُفاجئ من أعرفهم وأتعامل معهم يومياً. سحبتُ تلفوني من جيبي، والتقطتُ صورةً للحي الإسكندراني البحري، لا تظهر فيها الكاميرات أو معدّات الإضاءة، نشرتها على صفحاتي في مواقع التواصل الاجتماعي، وكتبتُ تحتها: "في مصر أخيراً!)".
بدأ التلفون يتراقص في جيبي بعد دقيقةٍ من ذلك، وكان الجميع يستفسر منّي متى ذهبتُ، وما إذا كنتُ في إجازةٍ أو أنّ الشركة أرسلتني في مهمّة عمل إلى هناك، ومتى سأعود... وهناك من أوصاني بألّا أنسى أن أجلب له تذكاراً.
بينما كنتُ أتصفّح ذلك كلّه مبتسماً، اتّصلتْ أمّي وسألتني بصوتٍ متهدّجٍ من فرط الجزع عن مكان وجودي. عندما أخبرتها بأنّ الأمر كلّه ليس إلّا مزحةً، تنهّدتْ بارتياح، فهي على عِلم بالمشاكل التي تواجهني في الشركة، وعدم رضاي عن فريق العمل أو تأقلمي معه، ونيّتي ترك العمل فور إيجادِ بديل، وقد ظنّت أنَّ البديل كان هذه المرّة في مصر بعد لبنان.
الإشعار الذي كنتُ أنتظره لم يَرِد، رغم أنّ صاحبته رأت الصورة
هدأ إيقاع الإشعارات تدريجياً، إلى أن توقّفت بعد أربعِ ساعاتٍ من نشري الصورة. لكنَّ الإشعار الذي كنتُ أنتظره لم يَرِد، رغم أنَّ صاحبته رأت الصورة. كانت علاقتنا قد مرّت بالعديد من المنعطفات والخضّات في الأسابيع الأخيرة، التي لم تخلُ منها على امتداد سنةٍ ونصف السنة، لكنّها صارت مؤخّراً أكثر تقارباً وحدّةً، كما أنّها راحت تبدو من دون أسباب. امتنعنا عن الحديث خلال عدّة أيام، فيما يشبه اتّفاقاً غيرَ معلنٍ بالابتعاد ريثما يصبح ما تعكّر بيننا رائقاً. لكن أن أوحي بكلّ الإقناع الذي انطلى على الجميع، بمن فيهم أمّي، أنّني صرتُ في قارّةٍ أُخرى ستفتح في حياتي صفحة جديدة، من دون أن يستثيرَ ذلك أيَّ تعليقٍ منها، فهذا ما لم يسعني فهمه أو إيجاد تفسيرٍ له.
ظللتُ أنتظر أن تبادر إلى محادثتي، بعد أن التمستُ في شدّة انشغالها بعملها عذراً لتأخّرها. لم أستطِع متابعة القراءة، أو استغلال يوم عطلتي في أيّ شيءٍ مفيدٍ آخر. بعد انقضاء أكثر من اثنتي عشرة ساعةً من الانتظار، وكنّا قد اجتزنا منتصف الليل، وفقداني أيَّ أملٍ في اتّصالها، قرّرتُ أن أحادثها. كتبتُ لها محيِّياً وسائلاً عن أحوالها، ردّت بالقول إنّها جيّدة، ثم سألتني مباشرةً، وقد بدا أنّها تذكّرت الأمر للتوّ، عن الصورة التي نشرتُها. فكّرتُ في كيفية ردّي عليها. قررتُ ألّا أقول شيئاً يعكس انزعاجي من تأخّر سؤالها، وأن أمضي في الكذبة. قلتُ لها إنّني وصلت إلى مصر في الصباح بالطائرة، وإنّني سأركب سفينة شحن بصورة غير شرعية بعد أيام من الإسكندرية إلى إيطاليا، حيث سأنزل لأعيش هناك، أو أتابع رحلتي بطريقةٍ ما نحو دولة أوروبية أُخرى، تتمتّع بمستوى اقتصادي ومعيشي أفضل. استفسرتْ منّي عن جدّيّة ما أقول، كتابةً أيضاً، من دون أن تُتعِب نفسها بالاتصال بي لتلتمس آثار المزاح أو الكذب في صوتي، كما فعلتْ أمّي، فأكّدتُ لها الأمر. حينها كتبتْ: "بالتوفيق إن شاء الله".
كان هذا تخلّياً، نكراناً، لامبالاةً بي وبحياتي ومشاعري، ركلاً لقلبي، اعترافاً بأنّني لم أعُد من الأشياء التي تهمّها فعلاً، والتي لا تتخلّى عن برودتها الفِطرية إلّا عند التعامل معها، بأنّني عِبءٌ سَعَدَتْ بالتخلّص منه بعد أن أثقل كاهلها لأشهر. لا يمكن لفتاةٍ أن تتغيّر كل هذا التغيّر في التعامل مع شاب ما لم يكن هناك شابٌّ آخر في حياتها، وهو ما كنتُ أشكّ فيه من دون أيٍّ دليلٍ، سوى تغيّر سلوكها في الفترة الأخيرة، وقد أكّده لي تخلّيها السريع هذا.
توتّرتْ أعصابي، وبدأتْ يداي ترتعشان وأنا أكتب لها على التلفون. كتبتُ الكثيرَ من الأشياء القاسية، التي أندم عليها أشدّ الندم الآن. كِلتُ لها مختلف الاتهامات، ووصفتها بأبشع الصفات، من دون أن أدع لها فرصةً للردّ الكتابيّ، إذ كنتُ أسرع منها بكثير، ومن دون أن أردّ على اتصالاتها الهاتفية، التي قرّرت أن تُجريها الآن فقط، أو أستمع إلى تسجيلاتها الصوتية.
قضيتُ أسابيع خانقة بعد ذلك، كنت أمشي خلالها على حبلٍ مشدودٍ بين جبلين، وكان التوازنُ عليه يعني بالنسبة لي توازنَ حياتي ذاتها، وفقدانه يعني فقدانها. هناك كبريائي أولاً، التي تمنعني من معاودة التواصل معها للمطالبة بما أعتبره حقّي في تفسير سبب سلوكها تجاهي ولامبالاتها بي، ومعرفة من هو البديل الذي أزالتني من حياتها لتُسقطه في مكاني، وبماذا هو أفضل منّي لتختاره وتحذفني. وثمّة عملي ثانياً، الذي زادت عزلتي فيه ونفوري خارج دائرة مجموعته بسبب انشغال ذهني وتشتته معظم الأوقات، وضعف تركيزي الذي ضاعف الملاحظات الموجّهة إليّ، والتي وصلت أخيراً إلى توجيه إنذارٍ مكتوبٍ لي، يحقّ لي بإنذارٍ آخرَ بعده قبل أن أُطرد، وهو الأمر الذي لا أريد حدوثه، خاصّةً مع عدم إيجادي لبديل في السابق، وتوقّفِ بحثي عن واحد بعد الانفصال، ولأنَّ المعاش أكثر من جيّد بالنسبة لي، إذ يفوق بأضعاف أفضل الوظائف التي شغلتها من قبل.
خضتُ خلال تلك الأشهر نوعاً من الإضراب عن الطعام. لم أمتلك شهيةً نحو أيِّ شيءٍ في الحياة. ربّما كنتُ أحاول أن أقتل نفسي لأنّي كرهتها بسبب عدم قدرتها على مبادلة الشعور ذاته مع من اعتبرتُ أنّها كرهتني.
ظلّت تتردّد في رأسي، خلال أيامٍ عديدة متتالية، عبارة ريتشارد فالانغان العبقرية، التي عبّرت عمّا أعيشه أبلغ تعبير: "ليس للرجل السعيد ماضٍ، أمّا الرجل الحزين فليس لديه شيءٌ آخر"، فقرّرت أن أوشمها في موضع مرئي من جسدي. لم أجد أنسب من باطن ساعدي الأيسر، الذي يبقى كُمّ كنزته مشموراً في الشتاء، عكس الكُمّ الأيمن الذي كثيراً ما ينزلق بسبب استخدامي لهذه اليد في أداء الأعمال المختلفة.
تلقّيت الإنذار الثاني بسبب الوشم، الذي اعتبره المدير غيرَ لائقٍ بشركته، وبموظّفٍ محترمٍ فيها. لطالما اعتبرته شخصاً غبياً، وربّما لذلك هو سعيدٌ ومستغرقٌ في عيش لحظته الراهنة. كنتُ متيقّناً من أنّي أسير في الطريق نحو الطرد بكلِّ ثباتٍ، فافتعلتُ مشكلةً دافعتُ فيها عن الوشم، وامتدحتُ قول فالانغان الحاذق والعميق، وذممتُ الشركة المتخلّفة ومديرها وجميع العاملين فيها. كنتُ مستعدّاً للعِراك معهم جميعاً، وقد تحلّقوا من حولي إثر صراخي وانفعالي، لكنّني تخلّيت عن ذلك مع قدوم رَجُلَي الأمن الضخمين. جمعتُ أغراضي القليلة وغادرتُ بصمت.
لم أخبر أمّي بما حصل معي. مضتِ الأسابيع من دون أن أبحث عن عملٍ آخر. كنتُ أقضي الوقت في التسكّع في الشوارع ليلاً، والنوم والاستلقاء والمشي داخل الغرفة والتنهّد والضجر نهاراً. إلى أن سمعتُ حديثاً بين الحلّاق وزبونٍ جالس على كرسي الحلاقة، بينما كنتُ أنتظر دوري، حول زوارق صغيرة تُبحر من شاطئٍ قريبٍ من ميناء طرابلس نحو أوروبا. اشتركتُ في الحديثِ، مستوضحاً عن تفاصيل تتعلّق بالأماكن التي تصل إليها هذه الزوارق، والأجر الذي تأخذه للراكب الواحد، وكيفية سداده، ومقدار الأمان الذي تتمتّع به.
كان في هذا الحديث شيئاً غيرَ واقعيٍّ، لا يتعلّق بكونه أمراً جدّيّاً للغاية يتقاطع مع المزحة التي أطلقتها قبل أشهرٍ، بل يتعلّق، كما أدركتُ بينما أكرِّر استرجاعه في غرفتي، بأنّه دار أمام مرآة. كان كلٌّ من الحلّاق وزبونه يتحدّث مع الآخر من خلال المرآة، وكأنّه يتحدّث من خلالها مع نفسه، كما صرتُ أفعل مؤخراً في مرآة الحمّام، لعدم وجود من أتحدّث معه في شؤون حياتي المعقّدة الكثيرة ومصاعبها المتزايدة.
كان الشاطئ صخرياً، وعشرات الأشخاص متوزّعون على امتداده، يبدون مثل صخور أُخرى في النور الضعيف للقمر شبه المكتمل، الذي تعبر أمامه غيوم بيضاء خفيفة مسرعة. ظهر الزورق في الماء، بعد أن دُفِع من مخبأ قريب، وأُزِيلت عنه أغصان أشجارٍ وأكياس خيش كانت تُغطّيه. همس صوتٌ خشنٌ آمراً إيّانا بالتقدّم نحو الزورق، بدءاً من الأشخاص الأقرب إلى المياه.
لم يكن الشاطئ صخرياً، بدا هكذا فقط. نهضتِ الصخور كلّها، وبدأت الزحف نحو الأمام. عِبتُ على هؤلاء الناس فوضاهم التي يجب عليهم التخلّي عنها في أوروبا، وقلتُ إنّه لا داعي للاستعجال، فلا بُدَّ من وجود ثلاثة مراكب أُخرى أو أربعة لتستوعب هذا العدد كلَّه من الركّاب، الذي بدا الآن أنّه يبلغ المئات، بالإضافة إلى ما يحملونه من أكياس صغيرة فيها بعض الطعام، وأولادٍ باكين مضمومين إلى الصدر كحقائب ثمينة.
لا مراكب أُخرى، ولا حتى واحداً! أُمِرنا بترك أكياسنا على الشاطئ، وحُشِر الجميع على متن الزورق بأكتافٍ متراصّة، ظهر واحدنا ملتصقٌ بصدر الآخر. أجاب المهرّبون على الاستعطافات والترجّيات والمناشدات، التي تعالت أكثر بفعل ترنُّح المركب تحت ثقلنا الكبير، بالأصوات المعدنية الحادّة لأسلحتهم الآلية الرشّاشة.
بدا منذ الدقائق الأُولى بأنّ المركب يغوص نحو الأسفل أكثر ممّا يُبحر نحو الأمام. لم تكن سُتَر النجاة كافيةً للجميع بالطبع. ألبسناها لمن لا يُجيدون السباحة من النساء، اللواتي احتضنَّ أولادهنَّ إليها، فيما تمسّك الباقون بعبوات بلاستيكية كبيرة مملوءة بالماء. بعد حوالى ساعتين من الإبحار تعطّل المحرّك، إذ ناء بحِملٍ ضخمٍ من المستحيل أن يبلغ به أيَّ بَرٍّ. حدث ذلك بالتزامن مع اشتداد العاصفة، التي لم يكن لها على الشاطئ أيّ أثرٍ يوحي ببلوغها هذا العنف.
عندما يغرق الناس تلتهم الأسماك عيونهم أوّلاً، قبل أن تتفرّغ لمحو بقية الجسد. كانت العديد من الأسراب تتجمّع حول الرؤوس، حتى تحجب كامل الجزء العلوي من الجسد، ثم تبتعد تاركةً الجثّة تواجه مصيرها بمحجرين فارغين، يوسّعان مفاجأتها من هول ما حدث لها.
أعرف ذلك لأنَّي رأيته، فالأسماك لم تبدأ بالتهام عينيَّ، بل أحاطت بساعدي الأيسر، وشرعت تنهش الجِلد حيث وُشِمتْ عبارة فالانغان.
* كاتب من سورية